السويس – حسام الدين أحمد:
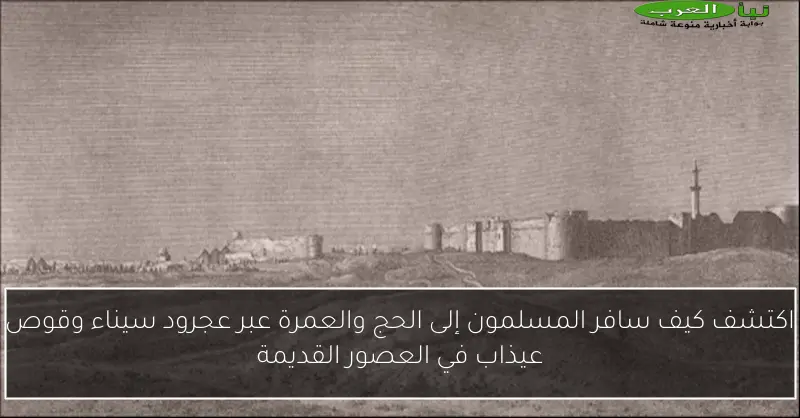
شوف كمان: ماليزيا تستعد لإطلاق أكبر حملة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة بـ1000 سفينة
على مدى أكثر من عشرة قرون، كانت السويس تمثل المحطة الأساسية على درب الحاج المصري، وكانت بمثابة بوابة العبور إلى الأراضي الحجازية قبل أن تُقسم شبه الجزيرة العربية إلى الدول المعروفة اليوم، حيث كانت قلعة وخان عجرود من المحطات البارزة على هذا الطريق.
بيت للضيافة
كانت القلزم، الاسم القديم للسويس، نقطة انطلاق وبوابة عبور إلى مكة، حيث كانت قلعة وخان عجرود من أهم محطات العبور للقوافل القادمة من الفسطاط، وكانت تُستخدم لتزويد الحجاج بالمؤن والمياه قبل استكمال رحلتهم برًا أو بحرًا.
يقول الدكتور سامي عبد الملك، مدير عام آثار شرق الدلتا الأسبق، إن قلعة عجرود اكتسبت شهرة كبيرة جعلتها واحدة من أهم المحطات لتزويد الحجاج بالمؤن قبل ركوب البحر، ويضيف أن الرحالة المغاربة والأندلسيين اهتموا بتوثيقها في رحلاتهم، نظرًا لأنها كانت مصدرًا رئيسيًا للمياه على طريق الحاج المصري، حيث تزوّد بها الحجاج من مصر وأفريقيا والأندلس.
قلاوون والغوري
يوضح الدكتور سامي، الباحث المتخصص في القلاع وطريق الحاج المصري، أن القلعة أنشئت في عصر المماليك، إذ قام السلطان الأشرف أبو النصر قنصوه الغوري بتشييدها عام 914 هـ/ 1508-1509م، تحت إشراف الأمير خاير بك المعمار، الذي أبدع في إنشاء العمائر السلطانية.
كما أضاف أن الخان المُحصن تم بناؤه في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، أحد سلاطين دولة المماليك البحرية، بإشراف الأمير الحاج سيف الدين آل ملك الجوكندار الناصري، نائب السلطنة في الديار المصرية، حيث أظهرت الفحوصات أن القلعة لم تُنشأ دفعة واحدة، بل بدأت بالمنشآت المائية والخدمية، وكان الخان أول ما تم إنشاؤه لتخزين مؤن الحجاج.
خدمات متكاملة
يقول الدكتور عبد الملك لموقع “نبأ العرب” إن القلعة بُنيت بجوار الحصن، ثم تطورت واتسعت، حيث احتوى منهل عجرود على العديد من المنشآت المعمارية المتنوعة، مثل خان حصين للمسافرين، ومساجد، وملحقات خدمية، بالإضافة إلى بئر وبرك وقنوات للمياه، وجبانة لدفن المتوفين من الحجاج.
تجارة وحج
قبل سبعة قرون، كانت قلعة عجرود تُعتبر منهلًا رئيسيًا ومكانًا لمبيت قوافل الحج في رحلات الذهاب والعودة، وكانت تشكل جزءًا من طريق التجارة بين مصر وبلاد الشام، بالإضافة إلى تجارة الشرق العابرة عبر ميناء السويس وموانئ البحر الأحمر واليمن وشرق آسيا.
يحدد الدكتور سامي عبد الملك موقع خان وقلعة عجرود، حيث يقعان على بُعد 20 كيلو غرب مدينة السويس، وما تبقى منهما الآن يبدو للمسافر على طريق “السويس- القاهرة”، حيث لا تزال أطلالهما بجوار مستودعات إحدى شركات البترول في المنطقة، ومكان الخان الحصين يقع شرق قلعة السلطان قنصوه الغوري على مسافة 150 مترًا.
السكة الحديد
ويتابع أن ما تبقى من القلعة والخان يفصل بينهما حاليًا شريط السكة الحديدية الذي تم الانتهاء من تنفيذه عام 1882، وقد بُني في منطقة منبسطة تمامًا، ولا تزال أطلال الخان تدل على تخطيطه، إلا أن تجريف الأرض المجاورة لإنشاء السكة الحديد ساهم في ضياع جزء كبير منه.
الانهيار
تضافرت عدة عوامل لتحديد مصير قلعة وخان عجرود وانتهاء دوره، حيث أدى تشغيل خط سكة حديد يربط بين السويس والقاهرة إلى تغيير وسائل السفر من القاهرة إلى السويس، واستبدلت قوافل الحجاج القطار بالجمال والدواب.
وفقًا للسجلات الملكية، بدأت هجرة قوافل الحجاج من قلعة عجرود بشكل شبه رسمي في عهد الخديوي إسماعيل، وتم إلغاؤها في تلك الفترة نظرًا لعدم الحاجة إليها بعد تدشين خط سكة حديد القطارات بين القاهرة وميناء السويس.
مقال مقترح: حملة لمصادرة مكبرات الصوت في دمنهور لحماية طلاب الثانوية.. إليك الصور والتفاصيل
الأندلس وشمال أفريقيا
يقول عبد الرحيم ريحان، مدير عام بحوث الآثار والدراسات الأثرية بسيناء الأسبق، إن درب الحاج لم يكن مقتصرًا على الحجاج المصريين فقط، بل خدم أيضًا حجاج المغرب العربي وبلاد الأندلس وشمال أفريقيا، حيث كان الحجاج المسلمون يأتون إلى مصر، يصلون إلى مدينة القاهرة عبر دمياط والإسكندرية، ثم يتجهون إلى بركة الحجاج، وينضمون إلى القوافل المصرية التي تسلك طريق السويس، والذي كان معروفًا في ذلك الوقت بالطريق البري، حيث كانت أغلب مسافة الرحلة تتم على اليابسة.
بدأ بالفتح وانتهى بالمماليك
أضاف الخبير الأثري عبد الرحيم ريحان أن طريق الحج البري كان يبدأ من السويس وصولًا إلى مدينة ينبع شمال الأراضي الحجازية، وانقسم الطريق البري زمنيًا إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى من الفتح الإسلامي حتى نهاية حكم الدولة الفاطمية في مصر، والثانية من نهاية الحكم الفاطمي حتى أوائل حكم المماليك، أما المرحلة الثالثة فبدأت مع حكم المماليك واستمرت حتى عام 1303 هجرية، الموافق 1885 ميلاديًا، حيث انتهت تلك الحقبة بالتحول إلى الطريق البحري.
رحلة 500 كيلو
يكشف ريحان أن رحلات الحجاج البرية كانت تقطع سيناء عرضًا، تبدأ من القاهرة من منطقة تعرف باسم بركة الحاج، وصولًا إلى قلعة عجرود، وكانت القافلة تقطع طريقًا طوله 150 كيلو في تلك المرحلة، حيث كانت تهتدي للطريق وتحافظ على مسارها باتباع خط يضم 24 عمودًا حجريًا كانت بمثابة علامات دالة على الطريق.
بعد التزود بالمؤن والماء، تستكمل القافلة سيرها من عجرود إلى منطقة نخل بوسط سيناء، وهي بطول 150 كيلو أيضًا، وبعد الوصول لنخل، تتحرك القافلة بعرض سيناء متجهة إلى أقصى نقطة في رأس خليج العقبة، لتصل إلى مدينة العقبة بالأردن حاليًا، وتلك الرحلة مسافتها 200 كيلو.
بمحاذاة الشاطئ
بعد ذلك، يستكمل الحجاج سيرهم بمحاذاة الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، يمرون بمناطق حقل ومدين وينبع، وبدر ثم رابغ، وبطن مر، ومنها إلى مكة المكرمة.
يخبرنا ريحان أن كل مرحلة من الرحلة كانت تستغرق ثلاثة أيام سيرًا بالجمال والخيل، وبين كل مرحلة وأخرى كان الحجيج ينال قسطًا من الراحة، وكانت الرحلات كلها برية قبل حفر قناة السويس، وبعد الحفر كانت القافلة تعبر القناة بالفُلك للوصول إلى الضفة الشرقية، ثم تستكمل المرحلة الأخيرة داخل الأراضي الحجازية، والتي كانت أطول نسبيًا.
بري وبحري
يضيف ريحان أن رحلات الحجاج في مصر كان لها مسلكان، إما برًا، والذي ذكرناه تفصيلًا سابقًا، ويبدأ من القاهرة إلى السويس، ومنها إلى سيناء وصولًا إلى العقبة في الأردن، أو بالاتجاه بحرًا وعبور البحر الأحمر.
البحري أطول
يكشف ريحان أن أول طريق بحري للحج، اتخذه الحجاج المصريون والعرب في أفريقيا، وكان أطول نسبيًا، حيث كانت القافلة تخرج من القاهرة إلى مدينة قوص بمحافظة قنا حاليًا، وكانت تسير بمحاذاة نهر النيل وتقطع مسافة 640 كيلو.
“قوص- جدة”
بعد الوصول والاستراحة بقنا، يستكمل الحجاج السير في القوافل متجهين شرقًا، قاصدين ميناء عيذاب أو مكانه حاليًا مدينة القصير بالبحر الأحمر، وكانت تلك الرحلة تبدأ زمنيًا قبل شهر رمضان، وبعد وصول القافلة إلى عيذاب، كانوا ينتظرون أكثر من شهر الفُلك التي تنقل أمتعتهم ودوابهم إلى شاطئ البحر الأحمر الشرقي، حيث ينزلون بميناء جدة.
رحلة شجر الدر
إلا أن الطريق البري كان هو المسلك الرسمي للدولة الأيوبية، حيث سلكت السلطانة شجر الدر، زوجة الأمير الصالح أيوب، آخر ملوك الدولة الأيوبية، درب الحج المصري القديم عبر سيناء في العام 645 بعد الهجرة، الموافق 1247م، ولذلك اعتُبر الطريق مسلكًا رئيسيًا للحجاج كونه أقصر، لكن ذلك لم يستمر طويلًا.
الصليبيون أعادوا عيذاب
يصف ريحان وضع الطريق الذي يمر بصعيد مصر، حيث قل اعتماد قوافل الحجاج عليه، وأصبح طريقًا تجاريًا يسلكه التجار في مصر، ثم توقفت رحلات التجارة في ذلك الطريق عام 760هـ / 1359م.
يكشف الباحث الأثري أن الحروب الصليبية أعادت قوافل الحجاج مجددًا إلى طريق “القاهرة- عيذاب – جدة”، حيث تركوا درب الحاج القديم المار من السويس إلى سيناء، تجنبًا للمرور بأرض الشام، حيث دارت المعارك الصليبية التي كانت فيها الغلبة للغزاة القادمين من أوروبا.
